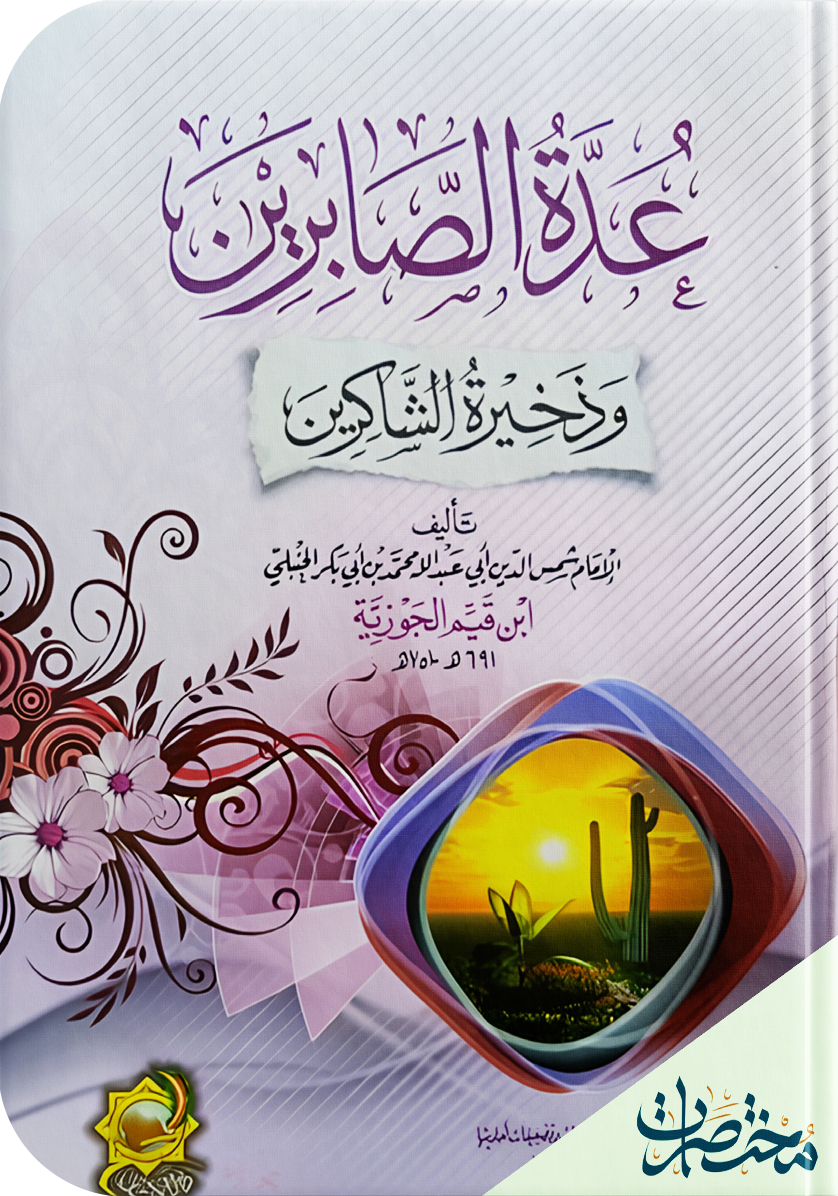الصبر ينقسم إلى قسمين، وهما: قسم مذموم وقسم ممدوح؛ فالمذموم: الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له، وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة. وقيل: الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء، وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف إذا كان كمال العبد وفلاحه في محبته.
وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله، وصبر بالله، قال الله تعالى: {واصبر وما صبرك إلا بالله}، [النحل: 127]، وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر، وهو الصبر مع الله، وجعلوه أعلى أنواع الصبر، وقالوا: هو الوفاء. ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وهي الصبر على أقضيته، والصبر على أوامره، والصبر عن نواهيه، فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات معه على أحكامه يدور معها حيث دارت فيكون دائما مع الله لا مع نفسه، فهو مع الله بالمحبة والموافقة، فهذا المعنى حق ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة، وإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر، فهذا حق ولكن جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم. واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هي ثبات القلب بالاستقامة معه.
"قال أبو علي: «فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معيته»".
كل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا، فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه، ويذم على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا، ولم ينتزع عنه مكروها، وأن المقدور لا حيلة في دفعه، وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله، فالجزع ضره أقرب من نفعه، فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود، فما أجدر به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره، وقال بعض العقلاء: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع، وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين. وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا، فيصبر صبر الموثق للضرب، وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن، واللئيم يصبر في طاعة الشيطان، فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم.
"قال بعض العقلاء: «العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر»".
لما كان الصبر مأمورا به، جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه، وكذلك ما أمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أنه ما قدر داء إلا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله، فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن، وهو يتركب من مفردين هما: العلم والعمل، فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان، فلا بد من جزء علمي وجزء عملي. فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص، فإذا عزم أحدهم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور أحدها: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة، إما بنوعها أو بكميتها وكثرتها، فليحسم هذه المادة بتقليلها، فإن لم تنحسم فليبادر إلى الصوم فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها؛ ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا.
الثاني: أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر، فليقصر لجام طرفه ما أمكنه؛ فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر، والنظر يحرك القلب بالشهوة.
الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام؛ فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أباحه الله سبحانه غنية عنه، وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس.
الرابع: التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر.
الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها.
وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور أحدها: إجلال الله - تبارك وتعالى - أن يعصى وهو يرى ويسمع، ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة.
الثاني: مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له، فإن المحب لمن يحب مطيع.
الثالث: مشهد النعمة والإحسان؛ فإن الكريم لا يقابل بالإساءة لمن أحسن إليه.
الرابع: مشهد الغضب والانتقام، فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب عليه.
الخامس : مشهد الفوات وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة.
السادس: مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق.
السابع: مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله.
الثامن: مشهد المعية وهما نوعان: معية عامة ومعية خاصة، فالعامة اطلاع الرب عليه، والخاصة كقوله: {إن الله مع الصابرين}.
التاسع: وهو أن يخاف أن يأخذه الله على غرة فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة.
العاشر: مشهد البلاء والعافية فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها.
الحادي عشر: أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومته على التدريج قليلا حتى يدرك لذة الظفر.
الثاني عشر: كف الباطن عن حديث النفس، وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها.
الثالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى.
الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي أمر عباده بالتفكر فيها.
الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها.
السادس عشر: تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيه وأزمة الأمور بيديه، وانتهاء كل شيء إليه على الدوام.
السابع عشر: أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين وأن محنته بين الجاذبين؛ جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين، وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين.
الثامن عشر : أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة، وأن تنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع، فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا قابلا ينزل فيه.
التاسع عشر: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه.
العشرون: أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كافيا في حصول المقصود، بل لا بد من أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله، ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب عن مداخل الفتنة والبعد عنها ما أمكنه.