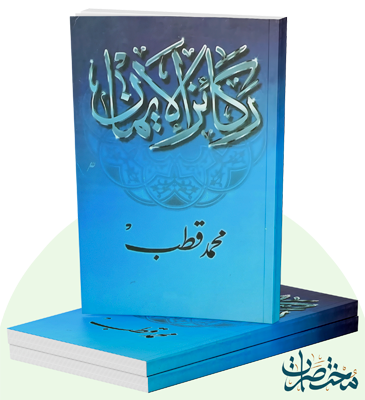الإيمان باليوم الآخر هو إيمان بالغيب؛ لأنَّ أحدًا لم يشهده بنفسه، وإنَّما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى عن طريق رسله الكرام، فسبيله هو النقل الصحيح ممَّا جاء في الكتاب والسنّة، والله الذي أخبرنا عن اليوم الآخر، وجعله ركنًا من أركان الإيمان، قد أودع الفطرة البشريّة القدرة على الإيمان بالغيب، فعن طريقها يؤمن بالله واليوم الآخر، فتتَّصل روحه بخالقه، ويستقيم على أمره، فتنصلح حياته في الدنيا والآخرة.
بعض الأدلة العقليّة والنقليّة على وجوب الإيمان باليوم الآخر: يقول الله تعالى: (أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَـٰكُمۡ عَبَثًا وَأَنَّكُمۡ إِلَیۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ) [سورة المؤمنون: الآية ١١٥]، وهذه الآية تدلّ على أنَّ الخلق يصبح عبثًا وباطلًا إذا لم يكن هناك يوم آخر يُبعث فيه الناس، ويحاسبون فيه على أعمالهم التي عملوها في الحياة الدنيا، ولا يجوز أن نتصور شيئًا من العبث أو الظلم في حقّ الله تعالى، كأن يفلت الظالم الذي بغى في الدنيا من العقاب في الآخرة، أو أن يُبتلى المؤمن فيصبر حتَّى يموت ثمَّ هو لا يجد لذلك جزاء بعد الموت، فحاشا لله أن يُساوي بين الظالم والمظلوم فيجعل نهايتهما واحدة، أو يتركهما سدًى بلا حساب ولا عقاب.
الحقائق التي يشملها الإيمان باليوم الآخر:
يشتمل الإيمان باليوم الآخر على مجموعة من الحقائق وردت في الكتاب والسنّة، وهي:
فتنة القبر وعذابه ونعيمه: فقد كان النّبيّ يتعوَّذ في دعائه من عذاب القبر، ونحن لا نستطيع أن نعلم على وجه اليقين كيف تكون صفة النعيم والعذاب في القبر، فذلك غيبٌ لم يحدّثنا الله ورسوله بكلّ تفصيلاته، وكلّ ما نعرفه أنّ الميّت حين يُدفن في قبره، يدخل عليه ملكان فيقيمانه، ويقعدانه، ويسألانه عن عمله في الحياة الدنيا، فلا يُجيب إلَّا بالحقّ، ثمَّ إنَّه يجد على إثرها قبرهُ روضة من رياض الجنّة، أو حُفرة من حفر النّار بحسب أعماله التي سلفت منه.
الساعة وأماراتها: المقصود بها هي الساعة التي تنتهي عندها الدنيا، حين تنشقّ السماء وتنتثر الكواكب وتُزلزل الأرض، ولاقتراب الساعة أمارات، وقد اقتربت الساعة بالفعل منذ بعثة النّبيّ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم ، وتبدأ أحداث الساعة فعليًّا بالنّفخ في الصور نفختين؛ بالأولى يُصعق كلّ من بقى حيًّا في السموات والأرض فيخرّون موتى، وبالثانية يقوم الناس من قبورهم ليوم الحشر.
البعث: كان من أشدّ ما عجب له المشركون في مكّة، وشكّكهم في الساعة وكلّ ما يدور حولها قضية البعث، فقد استبعدوا عن الله عزّ وجلّ قدرته على بعث الموتى، والحقيقة أنّ قضيّة الخلق واحدة في الأولى والآخرة، فمن خلق هذا الكون، هو بالتبعيّة قادر على البعث والخلق من جديد، فالكون أصلًا قد خُلق من العدم، فكيف سيعجز الله عن إعادة خلقه مرّة أخرى؟!
الحشر: يبعث الله الموتى ثمَّ يحشرهم جميعًا، ليقفوا بين يديه ليسألهم عن أعمالهم. ويصف القرآن الكريم هول الحشر في سورة عبس في قوله تعالى: (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)، ولكنّ الناس ليسوا سواء في ذلك اليوم العصيب، وإنَّما تختلف أحوالهم باختلاف أعمالهم، فمنهم من يُلقى في روعهِ الخوف والفزع نتيجة سوء عمله، فهو مظلم الوجه مُكفهرٌّ، يُساق كالبهائم، ومنهم من يُلقى في روعهِ الطمأنينة والاستبشار، ويلقى الحفاوة والتكريم مُنتظرًا وعد ربّه، وهم المتَّقون الذين يُحشرون إلى الرحمن وفدًا.
الحساب: بعد أن يُحْشَرَ الناسُ في هذا الهول الذي يَشْغلُ الإنسانَ عن أقرب المقرّبين إليه في الدنيا، يبدأ العرض والحساب، ويقف النّاس بين يدي الملك العزيز الجبار، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتَّى يسألهم الله عن أعمالهم، يقول عزَّ وجلَّ: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة الحجر: الآية ٩٢- ٩٣]، ولا يملك النّاس حينها إلَّا أن يعترفوا بذنوبهم، وأن يَشهدوا على أنفسهم.
الصراط: بعد ميزان الأعمال وتقرير المصير، يذهب كل فريقٍ إلى مصيره، فريق إلى الجنّة وفريق إلى السعير، وهم في طريقهم يمرّون على الصراط، فمن كان مصيره النّار، فهو يهوي من الصراط إلى جهنّم، وأمَّا من كان مصيره إلى الجنّة فهو يرى النّار من بعيد ليعرف مصير الكفّار، ثمَّ يستمرّ في طريقه إلى الجنّة.
الجنّة والنّار: هنا نهاية الرحلة الطويلة التي بدأ طرف منها على الأرض في الحياة الدنيا، واليوم تصل إلى نهايتها. هنا تكتمل الصورة، ويحقّ الحقّ، ويصل كلّ شيء إلى قرار، فالذين استقاموا على طريق الإيمان بالله، والتزموا بأوامره، وتجنّبوا سخطه، وصبروا على ما لاقوا من الأذى؛ فأولئك هم الذين استحقّوا رضوان الله وجنّته. وأمّا الذين كفروا وكذّبوا، وخالفوا أوامر ربّهم، واستمتعوا في الدنيا بغير الحقّ، فأولئك من استحقّوا أن يخلَّدوا الجحيم الأبديّ.