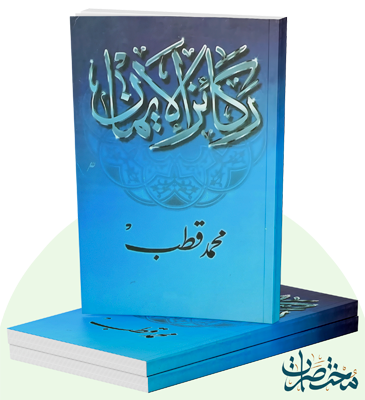وجوب الإيمان بالرسل
الإيمان بالرسل ركنٌ من أركان الإيمان، فلا يعدُّ الإنسان مسلمًا ولا مؤمنًا حتَّى يؤمن بأنّ الله قد أَرسل إلى البشر رسلًا من أنفسهم يُبلغونهم الحقّ المنزّل إليهم من ربّهم، ويبشِّرونهم وينذرونهم، ويبيّنون لهم حقيقة الدين، وعلى المُسلم أن يؤمن بالرسل جميعًا، ولا يُفَرِّق بين أحدٍ منهم. وقد جعل الله الإيمان بالرسل ركنًا من أركان الإيمان، وذلك لدور الرسل الهامّ في التعريف الحقّ بالله تعالى، وفي تقرير عبادته كما يُريد لهم أن يعبدوه، فبدون هؤلاء الرسل ستغرق البشريّة في ضلالاتها، وسيعبد الناس ما تُملي عليهم خيالاتهم من دون الله، مثلما عبدوا الشمس والنّار والأصنام وغيرها.
حقيقة النُّبوَّة
النُّبوَّة والرسالة هي اصطفاء خالص من عند الله، وليست شيئًا يكتسبه العباد من أنفسهم، فلا يد للإنسان فيها ولا اختيار، فالنبوّة في حدّ ذاتها هي مرتبة فوق مراتب البشر العاديّين، فإذا اختار الله واحدًا من البشر الممتازين ليجعله نبيًّا، فإنّه يرفعه من مكانهُ الذي كان فيه، ليضعه في مرتبة جديدة عالية لم يكن ليصل إليها من نفسه مهما اجتهد، وهي مرتبة الاتّصال بالله عن طريق الوحي.
الوحي وأنواعه
قال الله تعالى: (وَمــَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيــًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُــولًا فَيُوحِيَ بِــإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) [سورة الشورى: الآية ٥١]، وتُبين هذه الآية أنواع الوحي وأنّه يكون بإحدى طرق ثلاث؛ فإمّا أن يُلقى في النفس مباشرة فتعرف أنَّه من الله، وهو ما يُسمّى بالإلهام كرؤيا سيدنا إبراهيم أنّه يذبح ولده إسماعيل، وإمّا أن يكون الوحي من وراء حجاب كما كلّم الله موسى عليه السلام وذلك بدون أن يرى موسى ربّه، وإمّا أن يُرسل الله الملَك المكلّف بتبليغ الوحي فيوحي إلى الرسول ما يشاء الله تعالى، وذلك يحدث بعدّة طرق قد بيَّنها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فمنها ما كان يُلقيه الملك في روعه دون أن يراه، ومنها تَمثُّل المَلك في صورة رجل يتحدّث معه، بالإضافة إلى طرقٍ أخرى غير ذلك.
حاجة البشر إلى الرسالة
خلق الله البشر وهو أعلم باحتياجاتهم، كحاجتهم إلى الغذاء والكساء والمأوى، وحاجتهم إلى المعرفة والعلم والهداية والرزق وغيرها، وتكفّل الله لهم بهذه الاحتياجات؛ لكونهم لا يملكون شيئًا بغير تلك الكفالة الربانيّة، ولكنّ الإنسان ظنّ أنّ كلّ ذلك إنّما هو من عنده لا من عند الله، وأنّه يُمكنه أن يُدبّر أُموره بعقلهِ فقط بدون الحاجة إلى الله، متناسيًا أنّ عقله هذا من الأساس إنَّما هو هبة من عند الله، وقد غفل كذلك عن أنّ الله قد جعل لعقله طاقة محدودة لا يُمكنه أن يتعدّاها، وإنّما حمله على كلّ ذلك الانحراف اتّباع الهوى والشهوات، والواقع أنّ وضع المنهج الصالح لحياة البشر يحتاج إلى أمورٍ لا يُمكن للعلم البشريّ أن يحيط بها؛ مثل المعرفة الحقيقيّة الكاملة بالكيان البشريّ، والإحاطة الكاملة بماضي الجنس البشريّ وحاضره ومستقبله، وأمور أخرى لا يمكن لأحد غير الله تعالى التوصّل لأسرارها وحقائقها، فالمنهج الكامل اللازم لصلاح البشريّة لا يُمكن أن يأتي إلَّا من عند الله وحده.
مهمّة الرُسل: إنّ المهمّة الأولى للرُسل هي هداية البشريّة إلى معرفة الخالق وتوحيده، فالله يُرسل الرُسل ليُعرّفوا البشر بحقيقة خالقهم، وحقيقة صفاته وأسمائه الحُسنى، حتَّى يعبدوا الله العبادة الصحيحة والتي تتطلَّب اتَّباع ما أنزل الله من التشريع. أمّا المهمّة الثانية للرسل، فهي تعريف الناس بالمنهج الحقّ الذي تستقيم به الحياة، عن طريق تبليغ ما أوحى به الله إليهم، بالإضافة إلى مُهمّة أخرى وهي التربية؛ فالرسول عليه أن يبذل جهدًا في التوجيه والملاحظة، والصبر على انحرافات الناس حتَّى تستقيم، وذلك باللين والمودّة. ووسيلة الرسل في تربية أتباعهم تبدأ من أنفسهم؛ بأن يكونوا هم القُدوة في كلّ ما يدعون الناس إليه، وهي منهجية تفتقر إلى الصبر وسعة الصدر وإلى التذكير الدائم بالله، وتحتاج أيضًا إلى مصاحبة الناس حتَّى تمكن ملاحظتهم ومتابعتهم، وإلى معرفة طبائع النفوس ومداخلها لتقديم التوجيه المناسب لها.
أثر الرسل في حياة الناس: الرسل أعظم الناس أثرًا في التاريخ الإنسانيّ كلّه؛ وذلك لأنّهم يحملون معهم الإصلاح الجذريّ للنفس البشريّة، فبرغم امتلاء التاريخ بالقادة والزعماء والمُصلحين؛ إلَّا أنّ تأثيرهم كان محدودًا؛ وذلك لأنّهم غالبًا ما كانوا يتصدّون لحلّ مشكلة جزئيّة في حياة أقوامهم، وهم يحلّونها في نطاق بصيرتهم البشريّة المحدودة، كما أنّ شخصيّاتهم نفسها لا تخلو من انحرافاتٍ أو نقصٍ في بعض الجوانب.
فالفلاسفة مثلًا يعيشون في أبراجٍ عاجيّة في عزلةٍ عن الناس، وبالتالي فإنّهم لا يتمكّنون من تقديم حلول للمجتمع المُصاب بالعلل والانحرافات إلَّا على هيئة أفكارٍ نظرية غير واقعيّة وغير قابلة للتطبيق. أمّا الأنبياء فشأنهم مُختلف لأنّهم لا يتكلّمون بأهوائهم ولا ينطلقون من تصوّراتهم الخاصّة، ولا حتَّى من تصوّرات البشر المحدودة، وذلك يتبيّن في قوله عزّ وجلّ: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [سورة النجم: الآية ٣-٤].
وهم بذلك التوجيه الربّانيّ، لا يتعاملون مع المشكلات الجزئيّة العارضة، وإنّما يتعاملون مع الجذور العميقة للمشكلة، كما أنّ الحلول التي يُقدّمونها ليست أفكارًا إصلاحيّة نظريّة خالصة كأفكار الفلاسفة، وإنّما هي مناهج عمليّة مُنزَّلة من عند الله العليم الخبير.
كما أنّ الوسيلة الحقيقيّة العظمى التي يَسلُكها الأنبياء في إصلاح الحياة البشريّة هي ربط القلب البشريّ بالله، حتَّى يتطلّع إليه ويخشاه، وهي أفضل الوسائل في الإصلاح، وأكثرها أثرًا في واقع الحياة. وأخيرًا، فإنّ الرُسل ينفردون عن غيرهم من المُصلحين بالعلم النافع في الدنيا والآخرة؛ لأنّ أغلب المُصلحين لا يُوجّهون البشر إلّا إلى النفع الدُنيويّ، ولا يُوجّهونهم أبدًا إلى الله واليوم الآخر. فذلك العلم النافع هو المعرفة اليقينيّة بالله واليوم الآخر، وهو اتّباع ما أنزل الله في الدُّنيا، وهو العلم الذي يتلقّاه الأنبياء والرسل من الله مُباشرة عن طريق الوحي؛ لذلك فعن طريق العلم الربانيّ النافع وحده، صَلُحت أحوال الناس خلال التاريخ، واستُخدم العلم الأرضيّ في ظلِّهِ، في نفع الناس وتحقيق البرّ وتمكين الخير.
فضل الرُسل على تقدُّم البشريّة: حين نتحدّث عن تقدّم البشريّة، فإنّما نتحدّث عن تلك القيم والمَبادِئ التي تجعل من الإنسان إنسانًا، مثل كيفيّة تعامل الإنسان مع ربّه ومع نفسه ومع الآخرين، وبصرف النظر عن حظّه من التقدّم المادّيّ، والفضل الأكبر في هذا التقدّم يرجع للأنبياء والرُسل؛ لأنّهم هم من قرَّروا تلك المَبادِئ والقيم في واقع الأرض، ولذلك سنجد أنَّ الفترات المُشرقة في تاريخ البشريّة كلّه، هي الفترات التي سادت فيها تعاليم الرسل، وكانت واقعًا يُعاش بالفعل.
مهمّة التعليم الأساس: إنّ مهمة التعليم الأساس هي تربية الناس على تلك القيم والمَبادِئ، التي جاء الرسل ليحقِّقوها في واقع الناس، وقد كان سيّدنا محمّد هو المُعلّم الأوّل والمُربّي الأكمل. ومهمّة التعليم الأولى ليست في مجرَّد إعطاء المعلومات وتكوين الخبرات؛ وإنّما هي في تأهيل القلب الذي سيستخدم هذه المعلومات والخبرات، وذلك بتأديب هذا القلب بأدب النُّبوّة، وتحقيقه بحقائق مكارم الأخلاق؛ من أمانةٍ وصدقٍ واستقامةٍ ونظافةٍ للظاهر والباطن وغيرها من الفضائل، فحينها يصيرُ الإنسان إنسانًا صالحًا كما يُريده الله.
جناية النزعة الماديّة الإلحاديّة على البشريّة: إنَّ الجناية الكبرى للنزعة الماديّة الإلحاديّة الشائعة اليوم تتمثَّل في حرمانها للبشريّة من الاهتداء بالمنهج الربانيّ والاقتداء بهدي النُّبوّة، فقد قطعت تلك المادّية المُلحدة ما بين الناس والله، فأوصدت قلوبهم عن الاستماع لوحيه، وأنكرت رسالاته ورُسله، ونتيجة لذلك أصبح الشيطان هو المعبود في الأرض بدلًا من الله، وصار النّاس عبيدًا للآلة، وعبيدًا للشهوات تملكهم ولا يملكونها. وحينما ابتعد الإنسان عن المنهج الربّانيّ، ساءت أخلاقه، وغلبت عليه المنفعة الماديّة، واتَّجه نحو الإباحيّة، وأُصيب بالاضطرابات النفسيّة والعصبيّة وإدمان المخدرات، وكلّ ذلك في النهاية هو حصيلة التخلّي عن منهج الله.
صفات الرسل: أَوَّلًا: بشريّتهم، فكلّ الرسل الذين أُرسلوا من عند الله للناس كانوا بشرًا، وكانوا ينطقون بلغة أقوامهم الذين أُرسلوا إليهم. وقد كان النّاس في الجاهليّة لا يتصوّرون أنّ الوحي يُمكن أن ينزل على واحدٍ مثلهم من البشر، وإنّما كانوا يظنّون أنّ الوحي سينزل مع نزول ملك من السماء، وهم في ذلك غافلون عن الحكمة الكبرى من إرسال الرسل بشرًا، وهي تربية النّاس على اتِّباع الحقّ، ليكون الرُسل البشريّون قدوة عمليّة لهم في الحياة.
ثانيًا: عصمتهم، إنّ الرسل معصومون فيما يبلَّغون عن الله، فهم لا يُخطئون في التبليغ عن الله، ولا يُخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم، فقد عصمهم الله من الخطأ في هذه الأشياء؛ لأنّ الأمر لا يستقيم إذا أخطأ الرسول في التبليغ عن الله، وفي تنفيذ ما أوحى الله به له، وذلك لا يعني أنّهم معصومون مطلقًا من الوقوع في الأخطاء في غير ما يتعلّق بالوحي، وذلك كما وقع لنّبي الله داود، حين حكم لأحد الخصمين قبل أن يستمع لقول الخصم الآخر.
ثالثًا: مجال القدوة بهم، يبعث الله رسله من صفوة خلقه، ويختارهم من ذوي الصفات التي تصلح للأسوة والقدوة، وأوّل ما يرى النّاس في سلوك الرسول هو الإيمان الذي يدعوهم إليه، فهم يرونه يدعو إلى عبادة الله الواحد بدون أن يستند إلى جاهٍ أو سلطان، ويرونه وهو يحارب السُلطة الغاشمة مُستندًا إلى الله وحده، ويرونه وهو ثابتٌ على موقفه لا يتأثَّر بالمُغريات التي قد يتعرّض إليها أحيانًا، والنّاس تحتاج أن ترى كلّ ذلك واقعًا ماثلًا أمام أعينهم؛ كي يقتدوا به، وكأنّه نموذج حيّ وتطبيق متجسّد وعمليّ لكلّ الأخلاق والقيم والمعاني التي يُريد الله منهم تطبيقها.
أولو العزم من الرسل: إنّ الصفة البارزة في أولي العزم من الرسل هي الصبر، وذلك كما في قوله تعالى: (فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُو۟لُوا۟ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ) [سورة الأحقاف: الآية ٣٥]، ومنهم سيّدنا نوح عليه السلام، فقد لبث ما يقرب من ألف سنةٍ يدعو قومه، دون أن يستجيب له أحد منهم فلم يؤمن معه إلّا قليلٌ، حتَّى أنّ امرأته وابنه قد كفرا برسالته. وبعد ذلك الصبر الطويل دعا نوحٌ ربَّه أن يُدمِّر القوم الظالمين، وأن ينصره عليهم، قال تعالى: (فَدَعَا رَبَّهُۥۤ أَنِّی مَغۡلُوب فَٱنتَصِرۡ) [سورة القمر: الآية ١٠]. وقد تحقَّقت المعجزة فإذا بالطوفان يُغرق الأرض اليابسة حتَّى ويهلك المُكذّبين جميعًا، بينما نجا المؤمنون في داخل الفُلك المشحون.
ومن أولي العزم أيضًا سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي كان يُساوي أُمَّة كاملة كما وصفه الله، وذلك في عمق إيمانه ورجاحة عقله، وهو الشيء الذي ظهر في قصّة محاجَّتهُ لقومه، حينما استدرجهم إلى التفكير في شأن الأصنام التي يعبدونها، وتظاهر أمامهم بأنّه تارة يعبد الكواكب، وتارة يعبد القمر، وتارة يعبد الشمس، حتَّى أعلن إعراضه أمامهم عن كلّ هذه الآلهة الزائفة التي تختفي واحدًا تلو الآخر، وأقرّ بعبادة الله الحيّ الذي لا يموت. وقصّة إبراهيم والنّار تدلّ على إيمان إبراهيم العميق بالله، فإبراهيم حينما واجه النار، لم يكن يعرف أنّها لن تمسّه بسوء، وهو الموقف الذي لا يصبر فيه إلَّا أولو العزم. ذلك بالإضافة إلى الابتلاء العظيم الذي أصاب إبراهيم حينما رأى في منامه أنّه يذبح ولده إسماعيل، وفهم أنّ الله يأمره بفعل ذلك، ولكنّ إبراهيم نجح في الابتلاء نجاحًا باهرًا، لا يقدر عليه إلَّا أولو العزم الأشدّاء.
وكذلك كان سيّدنا موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، بمحنة فراقه لأمّه، وقتله بالخطأ للرجل المصريّ الذي كان يقتتل مع رجل إسرائيليّ، وقصّة مواجهته لفرعون الذي كان طاغية عصره، ودعوته لبني إسرائيل بعد غرق فرعون والتي كانت بلا جدوى، إذ اتَّخذوا العجل الذهبيّ إلهًا لهم، ورفضوا الجهاد لدخول الأرض المُقدَّسة التي وعدهم الله بها؛ لذلك استحقَّوا اللعنة وباءوا بغضبٍ من الله.
ومن أولي العزم أيضًا، سيّدنا عيسى عليه السلام، الذي بدأت قصّته بمعجزة عظيمة، وهي ولادته بغير أب، بالمشيئة الربّانيّة فحسب. ممّا جعل النصارى يدّعون أنّ عيسى عليه السلام هو ابن الله لكونه ولد من غير أب. أمَّا بالنسبة لليهود، فقد أرسل الله عيسى إلى اليهود الذين شاع أكلهم للربا، وأكلهم أموال النّاس بالباطل، ولكنهم كذبّوه وحرّضوا على صلبه، ولكنّ الله ألقى شَبههُ على يهوذا الإسخريوطيّ، فصُلبَ بدلًا منه، ورَفع الله عيسى إلى السماء، وهكذا انتهت قصّة عيسى بمعجزة إلهيّة عظيمة مثلما بدأت.