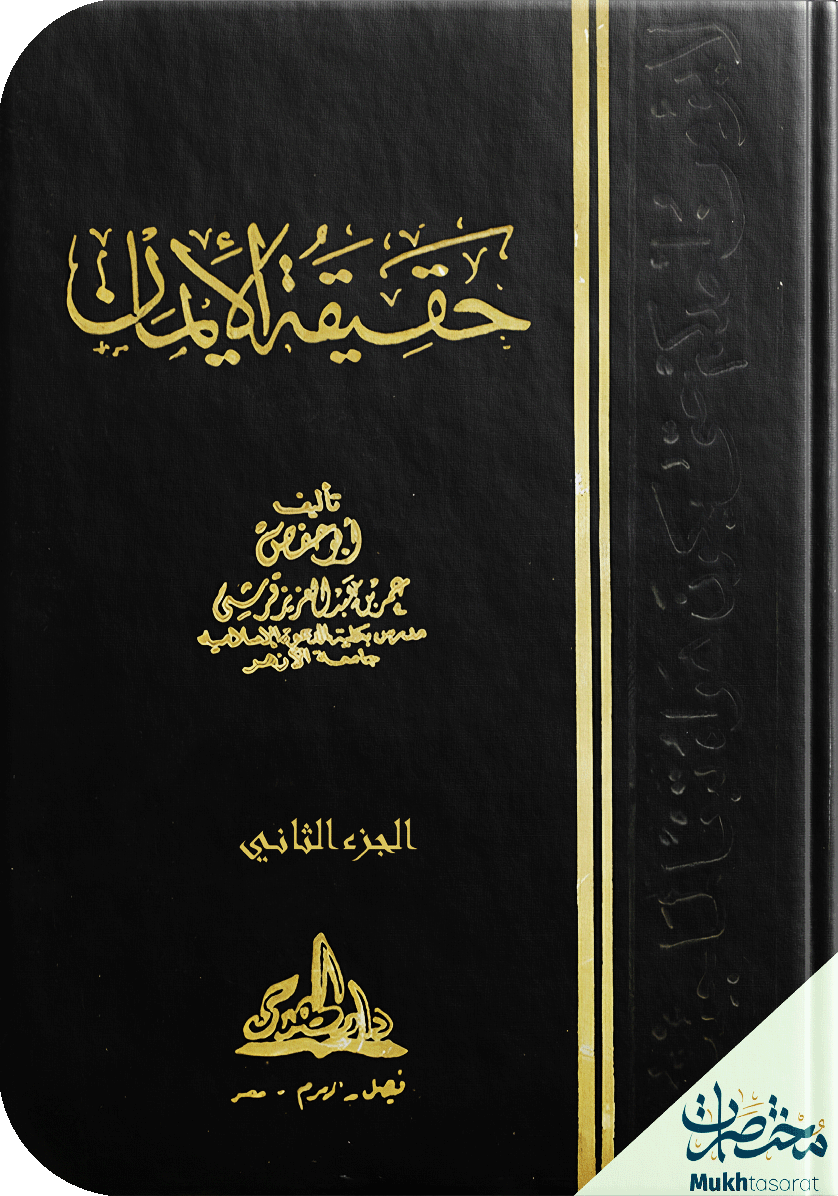تعرضت عقيدة القضاء والقدر لضربات عنيفة، وتشكيك سخيف، من أعداء الإسلام من يهود ونصارى وملحدين ومجوس وغيرهم ، فظهر أصحاب مبدأ نفي القدر، والقول بالجبر، وجماعات الاعتزال والتشغيع، حتى أن المسلمين أنفسهم أصبحوا الآن ، لا يفقهون معنى الإيمان بالقضاء والقدر على وجهه الصحيح. وقد اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر؛ فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، وقال بأن القضاء والقدر هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها، ومنهم من قال بأن لكل منهم تعريفا مختلفا؛ فقال بأن القضاء هو إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته، وأن القدر هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. كما قيل إن القدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والمكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحدا.
أنواع القضاء والقدر
هناك نوعان من القضاء والقدر وهما:
القدر المسلم به أو القدر المبرم، وهو القدر المرتبط بخلق الكون وتدبير النظام الذي ربط به، والسنن التي تحكم كل أجزائه، وذلك كما قال تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ [القمر: 49]. فهذا النوع من القدر فيه كل ما يجري من أحداث الحياة؛ كالحياة والموت؛ والقحط والجدب، وما ينزل بالإنسان من مصائب لم يتسبب هو فيها، وتحديد رزقه، وتقدير أجله. وهذا النوع من القدر يجب الإيمان به، والرضا به، والتسليم لله تعالى فيه.
والنوع الثاني: هو القدر المختلف عليه أو المعلق: وهو القدر المتعلق بأفعال العباد؛ حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها، وما هو مرتبط بالطاعة والمعصية والثواب والعقاب، وهذا النوع هو ما اختلف فيه وأثيرت حوله الشبهات، وأول من فعل ذلك كان غيلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك لزندقته في حدود المئة عام الأولى من الهجرة.
نزاع الناس حول القضاء والقدر
القدرية: القدرية هم أول من تكلموا في مسالة القضاء والقدر، وكان أولهم غيلان الدمشقي، وكانوا يؤمنون بنفي القدر المتعلق بأفعال العباد؛ بمعنى أن أفعال العباد لم تكتب في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء ، بل وزعموا أن الله لم يعلمها قبل وجودها، وقالوا قولتهم الشهيرة: " لا قدر ، والأمر أنف"؛ أي نفوا القدر المتعلق بأفعال العباد، والأمر أنف أي مستأنف، لم يعلمه الله قبل وقوعه، وقالوا أيضا إن العبد يخلق أفعاله بنفسه، وإن الله تعالى لا دخل له في ذلك ولا عمل، وما بنوا عليه هذه الأفكار هو عدة تساؤلات؛ منها: كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ويحرمه؟ وكيف يخلق الله أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها؟ وقد عرفت هذه الجماعة باسم القدرية أي نفاة القدر، وهم قد كفروا لإنكارهم القدر الذي دلت عليه نصوص الكتاب وسنة نبي الله، ولكن هذه الطائفة في الغالب قد ذهب باطلها، وانتهت نهائيا من الوجود.
الجبرية: هم طائفة من المعتزلة، وهم على العكس من القدرية، وأول من ظهر منهم هو الجعد بن درهم، والذي كان يتلقى مذهب الجبر من يهودي من يهود الشام، وهم يؤمنون بأن الإنسان لا يخلق أفعاله، ولا ينبغي أن تنسب إليه أفعاله إلا على سبيل المجاز، فهي نسبة فعل وليست نسبة اختيار وإرادة، وهي في الحقيقة أفعال الله يجريها على يد العبد دون إرادة منه ولا اختيار. وبالتالي فهم يرون أن الإنسان لا يجب أن يلام على أفعاله، مهما كانت فاسدة أو قبيحة، ومهما ارتكب من معاص، حتى قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما يختار مني ففعلي كله طاعات؛ فالعبد هنا كالريشة في مهب الريح؛ لا قدرة له ولا اختيار، وإنما هو مسير بالكامل، ومجبر على كل شيء ، وهي عقيدة أكثر ضررا وفسادا من عقيدة نفي القدر.
الإبليسية: هي فرقة مترددة تنسب إلى إبليس، وأصحابها مترددون بين إثبات القدر ونفيه، والقول بالجبر وعدمه، فهم يتساءلون كيف يجوز أن يكتب الله على العبد أعماله التي سيقوم بها حتما ثم يؤاخذه عليها؟ وإذا كان الله يعلم مصير العبد كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فكيف يأمر الله عبده إذا بفعل الطاعات وينهاه عن فعل المعاصي وهو الأمر الذي تم البت فيه وتحدد مصيره بالفعل؟ وانتهى هذا المذهب إلى الاعتراض على الله تعالى، ونسبة الظلم إليه، وهو المنزه عن الظلم، البعيد عن كل نقص، سبحانه ولا إله إلا هو.
أهل السنة والجماعة: وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهم قد سلكوا في ذلك مسلكا وسطا، بعيدا عن الغلو والتسيب، والإفراط والتفريط. وقد قام هذا المذهب على الدليل الشرعي من القرآن والسنة، والذي يقول بأن الله تعالى لما قدر ما للعبد وما عليه من خير أو شر، وسعادة أو شقاء؛ قد قدره مربوطا بأسبابه، فللخير أسبابه، وللشر أسبابه، وقدر أن العبد يأتي تلك الأسباب ويعمل بها بمحض إرادته التي قدرها له، وحرية اختياره الذي قضى له به، فلا يصل العبد إلى ما كتب عليه وقدر له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها، ولا مجبور على فعلها. والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره؛ وما يقع منه باضطرار وإجبار، فالإنسان ينزل من السطح بالسلم نزولا اختياريا فيعرف أنه مختار، ولكنه حين يسقط هاويا من السطح يعرف أنه ليس مختارا في ذلك. وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختيارا وما يقع اضطرار وإجبارا، بل إن من رحمة الله - عز وجل - أن من الأفعال ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شيء، كما في فعل الناسي والنائم والمكره، لا اختيار له ، ولا يؤاخذ بفعله؛ لذلك فإن الله تعالى إذا كتب على العبد السعادة أو الشقاء كتب له كذلك أنه يعمل بالأسباب التي تسعد أو تشقي لتتم السعادة أو الشقاء على أساس نظام الأسباب هذا.
مراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة
هناك أربع مراتب للقضاء والقدر؛ أولها هو العلم، وهو إيمان الإنسان بأن الله بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
والمرتبة الثانية هي الكتابة، وهي أن الله قد كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله سبحانه: ﴿ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ۗ إن ذلك في كتاب ۚ إن ذلك على الله يسير﴾ [الحج: 70].
وجوب الإيمان بالقضاء والقدر
لا يقبل إيمان المسلم إلا إذا آمن إيمانا راسخا بعقيدة القضاء والقدر؛ فهذه العقيدة قد دل عليها القرآن والسنة، فقال تعالى: ﴿ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم﴾ [التغابن: 11]، كما قال صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك)، فالسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
مسائل في القضاء والقدر
من المسائل المشهورة في قضية القضاء والقدر
مسألة
هل الإنسان مسير أم مخير؟
والواقع أن الإنسان مسير كتسيير الجماد والنبات والحيوان من حيث قوانين الحياة؛ كالجاذبية الأرضية وعملية النمو وإدارة أجهزة الجسم، وغيرها من الأمور التي لا إرادة له فيها، وهو مخير فيما تميز به على الجماد والنبات والحيوان وهو العقل والفكر، فالإنسان يمكنه اختيار أفعاله، وهذا هو سبب التكليف من الله، فلو لم يكن للإنسان حرية الاختيار لما كلفه الله تعالى وميزه على سائر المخلوقات؛ لذلك فيمكن القول بأن الإنسان مسير ومخير في الوقت نفسه. مسالة هل علم الله تعالى السابق يجبر العبد على الفعل؟ إن علم الله تعالى هنا ليس صفة جبر، وإنما هو صفة انكشاف فقط؛ فالله قد علم ما يكون من عبده باختياره؛ كالمرآة التي تكشف الصورة التي توضع أمامها، فالله يرى الأشياء على ما ستكون عليه في المستقبل، ولا يلزمها بأن تكون شيئا آخر غير ما هي عليه فعلا.
مسألة
هل القضاء والقدر يتنافى مع عدل الله؟ وهل العبد يخلق أفعاله بنفسه؟
الله هو الخالق وهو الفعال لما يريد، ولكنه هو العدل أيضا، وهو ما يعني أن الله لم يكلفنا إلا بما خلقنا صالحين لفعله، وصالحين لعدم فعله، ومهمة الرسل أن ترسم منهج الله لتقول لك: افعل كذا ولا تفعل كذا.
مسالة هل القضاء والقدر يتنافى مع الأخذ بالأسباب؟ معلوم أن الأخذ بالأسباب واجب، وتركها معصية، وأن الاعتماد عليها شرك، فعلى الإنسان أن يأخذ بأسباب السعادة، ويتجنب مزالق الشقاء؛ فليس القدر إجبارا على أن نفعل الشيء، وإنما هو إخبار عن علم الله تعالى بما سبق. مسالة في الهداية والضلال اختلف بعض الناس في تفسير فكرة الهداية والضلال كما جاءت في آيات القرآن الكريم، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون﴾ [النحل: 93]؛ فمعنى يهدي من يشاء هنا، أي أن الله يذلل العقبات ويهدي إلى طريق الخير لمن استمع لله وآمن به وأقبل عليه، فهنا تأتي المعونة له من الله. ويضل من يشاء تعني أن من اختار طريق الكفر والضلال من الناس فهو غير مستحق لعون الله له؛ فالعبد هنا من بدأ بالمعصية، ولا يمكن لله الحق العدل أن يعذب الإنسان على معصيته وقد كتبها عليه، كما لا يمكن لله أن يثيب الإنسان على طاعة قد كتبها عليه أيضا؛ فهذا يتنافى مع عدل الله عز وجل.
وأخيرا فإن حكمة الإيمان بالقدر تعلم الإنسان الا يجزع إذا مسه الضر، وتعلمه الا يفرح إذا حالفه النجاح، حتى يكون إنسانا متزنا ،راضيا بقضاء الله، تخلو أفعاله من التردد والحيرة، ويختفي من حياته القلق والاضطراب، فلا يحزن على ماض، ولا يغتم لحاضر، ولا يؤلمه هم المستقبل، فيكون أسعد الناس حالا وأهداهم بالا، وهو ما قال عنه صلى الله عليه وسلم: (عجبا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له). وختاما، فإن كل ركن من أركان الإيمان الستة المكونة لعقيدة المؤمن؛ يثمر للمؤمن ثمرة خاصة؛ فالإيمان بالله ثمرته حب الله سبحانه وتعالى، وثمرة الإيمان بالملائكة هي الاقتداء بطاعتهم لله، وثمرة الإيمان بالكتب هي معرفة وسيلة الإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته.
وثمرة الإيمان بالرسل هي معرفة تطبيق شرائع الله، وثمرة الإيمان باليوم الآخر هي أنه وسيلة إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وثمرة الإيمان بالقدر هي أنه وسيلة إلى ترك الحزن على ما فات، وعدم الخوف مما هو آت، والرضا بكل ما يجريه الله على العبد في هذه الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا