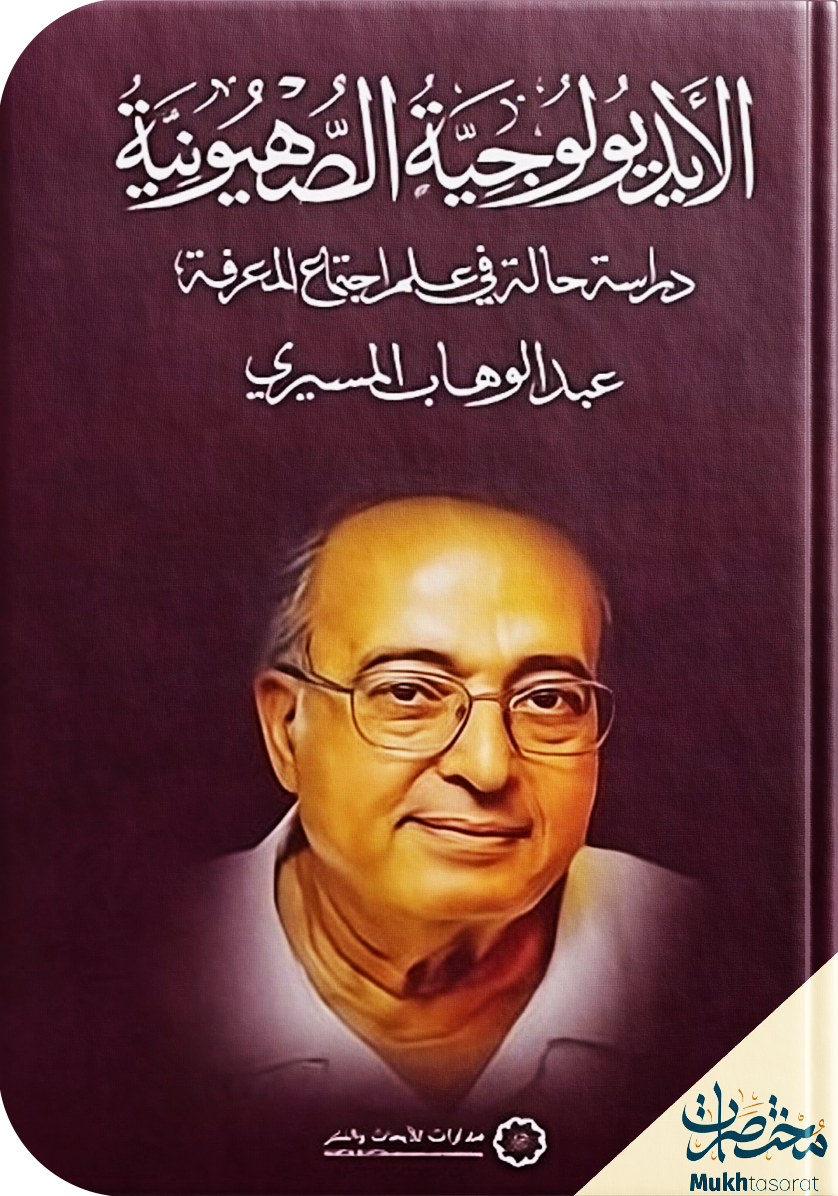هذه الدراسة يمكن تصنيفها على أنَّها دراسة تطبيقيَّة في علم اجتماع المعرفة، ويُعَدُّ كارل ماركس هو مؤسِّسَ هذا العلم، وقد ساهم ماكس فيبر، من خلال دراسته في علم اجتماع الدين في هذا المجال، وقد عرَّفه عاطف غيث بأنَّه العلم الذي يهتمُّ بالعلاقة بين أنساق الفكر والوقائع الاجتماعيّة.
ويرى برجر ولكمان أنَّ علم اجتماع المعرفة يمكن تعريفه من خلال تحديد مجاله وأهدافه: فهو علم يدرس كلَّ الظواهر التي تندرج تحت اصطلاح "معرفة"، بغض النظر عن مدى صدقها أو مدى تماثلها مع الواقع.
وعلم اجتماع المعرفة يدرس كذلك كيف تصبح الفكرة الذاتيَّة (الفرديَّة) معرفةً اجتماعية، ثمَّ واقعًا اجتماعيًّا.
وكلُّ تعريفات الواقع الاجتماعيِّ علاقةٌ بين طرفين؛ الطرف الأوَّل هو عالَم المنتَجات الفكريَّة (أيديولوجيَّات - فلسفات ...)، والثاني هو الواقع الاجتماعيّ والتاريخيّ، ومهمَّة هذا العلم هي دراسة العلاقة بين الطرفين.
وقد قام إلزورث فورمان، في كتابه علم اجتماع المعرفة، بتحديد موقعين هما:
الموقف النقديّ/الانعتاقيّ (ماركس ولوكاش وماركوزوها)،
أو موقف الاجتماعيّ/التكنولوجيّ (كونت دوركهايم وجورفيتش).
ويتَّفق الموقفان على الخطوط العريضة التي تحدِّد مجال علم اجتماع المعرفة، ويختلفان في بعض النقاط الأخرى، فالفريق الأوَّل يقوم بالتركيز على تحليل الأيديولوجيَّة السائدة في المجتمع، بينما الفريق الثاني يركِّز على تحليل المشاعر الجماعيَّة، مثل موقف الرجل العاديّ.
ومن هذا المنظور يرى أعضاء الفريق الأوَّل أنَّ مهمَّة العلوم الاجتماعيَّة هي كشف القوى الاجتماعيَّة المستغِلَّة، ويصبح دور العالم الاجتماعيّ، هو أن يكون ناقدًا ثوريًّا عقلانيًّا، أمَّا دوره من وجهة نظر الفريق الثاني فهو أن يكون المستشارَ المحترفَ، الذي يأخذ رأي غيره من الخبراء، ويكشف الأنماط المتكرِّرة في السلوك الإنسانيّ.
والصورة الأساسُ للمجتمع، من وجهة نظر الفريق الأوَّل، هي صورة الصراع، أمَّا بالنسبة إلى الفريق الثاني فالصورةُ الأساسيَّةُ هي صورة النظام. وقد توجَّهت مجموعة من الاعتراضات لعلم اجتماع المعرفة نذكر منها:
إنَّه لا يعطي أهميَّة كافية لمضمون التفكير ومدى صدق مقولةٍ ما أو كذبها.
إنَّ منتجات الإنسان الحضاريَّة متعدِّدة المستويات، ولذا فعلم اجتماع المعرفة هو علمٌ تبسيطيٌ، يردُّ هذه المنتجاتِ إلى وضع سياسيّ محدود.
إنَّ البناء الحضاريَّ الفوقيَّ، بعد أن يظهر للوجود؛ تصبح له حياته الخاصَّة، ويتحوَّل إلى جزء من تراث حضاريٍّ دائم.
إنَّ الأشكال الفنيَّة محكومةٌ بمنطقها الداخليّ، وتُعَدُّ انعكاسًا للأشكال السابقة، وامتدادًا لها.
وبعد هذا العرض القصير، قد يكون من المفيد أن نبيِّن بعض منطلقاتنا الخاصَّة بهذا العلم فرَغم وجاهة بعض الاعتراضات، إلَّا أنَّ ما يتصوَّره البعض نقطةَ قصور، يصبح هو ذاتُه موطن قوَّة، ولنأخذ على سبيل المثال، الاعتراض الأوَّل، وهو أنَّ علم اجتماع المعرفة يحاول ألَّا يحكم على مدى صدق مقولةٍ أو كذبها، كما أنَّه لا يعطي أهميَّةً كافيةً للمضمون، ولكنَّ العلم الذي يقفز إلى الحكم دون تفهُّمٍ للمنطق الداخليّ للأحداث هو علمٌ تجريديّ، ولذا لا بدَّ أن يحاول عالم اجتماع المعرفة أن يفهم منطق النسق الفكريِّ الداخليّ، بوصفه كيانًا متكاملًا مكثَّفًا بذاته، حتَّى يفهم قوانينه الداخليَّة، وقد حاولنا أن نفعل ذلك حينما حاولنا دراسة منطق الأيديولوجيَّة الصهيونيَّة من الداخل، ولكنَّ محاولةَ الفهم من الداخل لم تكن إلَّا وسيلةً لمعرفة الملامح الخاصَّة للنسق؛ حتَّى يمكننا مراقبته في احتكاكه مع الواقع.
ولعلَّ موقفنا من الاعتراضات الموجَّهة لعلم اجتماع المعرفة هو موقفُنا نفسُه من محاولة تصنيف التيَّارات المختلفة في هذا العلم إلى موقفين؛ إذ إنَّني أجد من الممكن تبنِّي الموقفين حتَّى يُكْمِل الواحد منهما الآخر، ففي هذه الدراسة قد تبنَّينا صورتين متناقضين:
صورة المجتمع ككيان عضويٍّ متماسك (الأيديولوجيَّة الصهيونيَّة والمجتمع الصهيونيّ من الداخل)، وصورة جدليَّة مبنيَّة على الصراع (الإنسان العربيّ الذي يحارب ضدَّ هذا المجتمع من الخارج)، وعلى عالم اجتماع المعرفة أن يكون المستشارَ المحترف، والناقدَ الثوريَّ العقلانيَّ الذي يعمِّق من وعي الجماهير.
وهذه الدراسة هي دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة، والحالة التي درسناها هي "الأيديولوجيَّة الصهيونيّة"، وقد وصف عبد الله العروي مفهوم الأيديولوجيَّة بأنَّه، مشْكِلٌ وغير بريء، وقد يصلح أداةً للتحليل، ولكنْ بعد عمليَّة فرز وتجريد، ويلخِّص عبد الله العروي القضيَّة على النحو التالي: يُستعمَل المفهوم في ميدان المناظرة السياسيَّة حينما نقول: إنَّ الحزب الفلانيَّ يحمل أيديولوجيَّة، ويُستعمَل في وصف رؤية المجتمع، ويستعمل المفهوم أيضًا في نظريَّة المعرفة.
وأمَّا التفسيرُ الاجتماعيُّ فيرى أنَّ الأيديولوجيَّة نسق من الأفكار التي تتشكَّل من خلال الواقع الاجتماعيّ، وليست حقيقيَّة بالضرورة، ومع هذا فهي قادرة على تجنيد الجماهير وتحريكها، أمَّا التفسير النفسيُّ فيرى أنَّ وظيفة الأيديولوجيَّة هي تهدئة التوتُّرات النفسيَّة، وذلك عن طريق وضع تفسير جديد يجعل من الممكن تَقَبُّل الموقف (الاجتماعيِّ أو التاريخيِّ).
أمَّا كليفورد جيرتز (وهو ممثِّل التصوُّرِ الحضاريِّ /الاجتماعيِّ للأيديولوجيَّة) فيرى أنَّ التصوُّرين الاجتماعيَّ والنفسيَّ قاصران، وأنَّ الأيديولوجيَّة تستمِدُّ قوَّتها من قدرتها على الإحاطة بالحقائق الاجتماعيَّة. ويمكن القول إنّ الأيديولوجيَّة تضمُّ كلَّ العناصر (السياسيَّةِ والحضاريَّةِ والنفسيَّةِ والاجتماعيَّةِ) في نسقٍ متكاملٍ يماثل الواقع الذي تدعو إليه.
لقد حاولنا في هذه الدراسة أن ننظر إلى الأيديولوجيَّة الصهيونيّة لنَصِفها، ولندرك منطقها الداخليَّ، بغضِّ النظر عن مطابقتها للواقع، كما ننظر إليها على أنَّها برنامج سياسيٌّ تبشيريٌّ، يحاول أن يغيِّر الواقع لحساب رؤية جديدة، وكيف أنَّ الفكرة الصهيونيّة تحوَّلت إلى واقعٍ من خلال الدعم الإمبرياليِّ أو من خلال الممارسات الصهيونيّة في فلسطين والغرب، وحاولنا في دراستنا للصهيونيَّة فهمها بوصف سماتها ودراسة أصولها أيضًا.