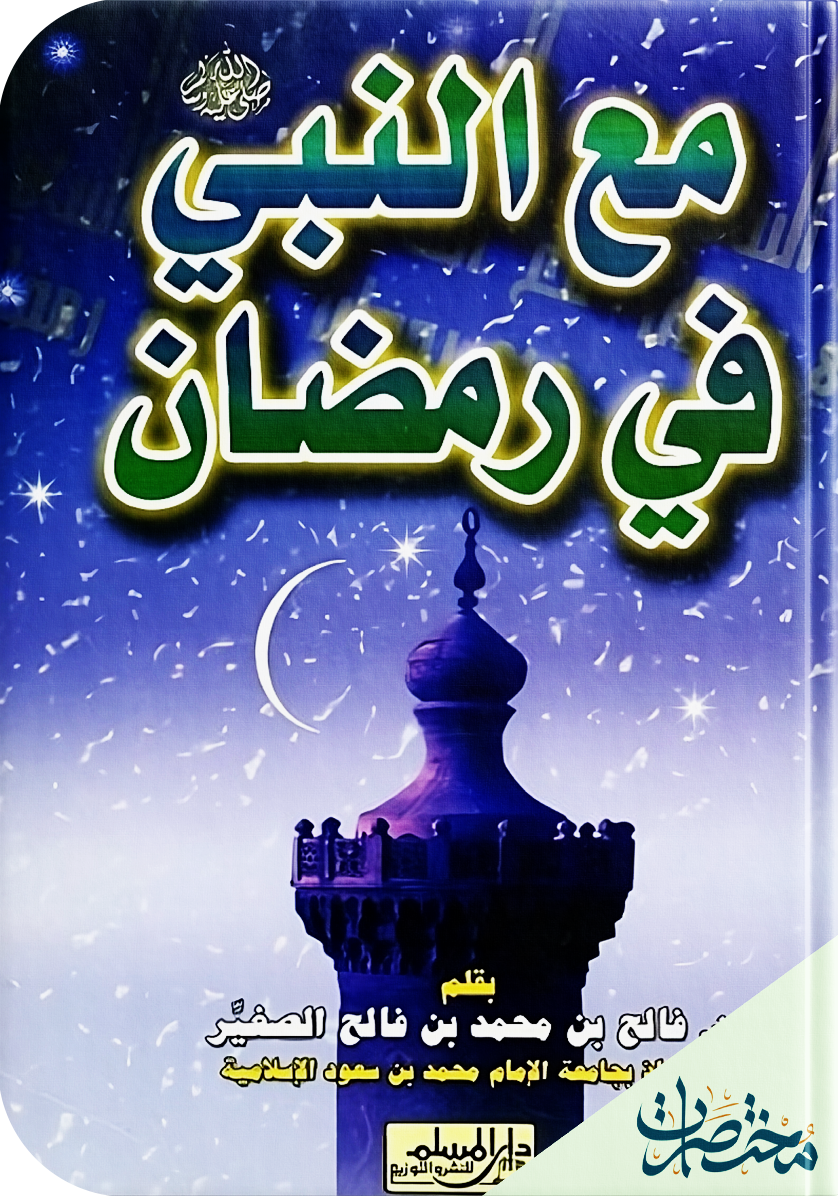روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها : "كان النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله".
وهذه النصوص الكريمة توضّح السيرة العطرة لنبيِّنا محمَّد، صلَّى الله عليه وسلَّم، في هذه الأيَّام الأخيرة من شهر رمضان، وترسم لأمَّته منهجًا يتَّبعونه في حياتهم، فرسول الله يجتهد في هذه العشر، ومن منهجه فيها إحياء الليل، فجعل استيقاظه وعمله الطاعات المختلفة في هذه الليالي المباركة في منزلة الحياة، ولا شكَّ أنَّ حياة القلوب وطهارتها بالذكر والقراءة والصلاة والإحسان إلى الخلق وكلّ ذلك مقرِّب إلى الخالق سبحانه وتعالى.
ومن هديه صلوات الله وسلامه عليه أنَّه يوقظ أهله ليشاركوه في هذه الأعمال وليأخذوا حظًّا من قيام الليل ومن الأجر والثواب. فينبغي إيقاظ الأهل والأولاد وحثّهم على قيام الليل والدعاء في العشر الأواخر من رمضان.
ينقل المؤلِّف قول الإمام ابن القيِّم عن الاعتكاف، وفحواه: شرع الله لعباده المؤمنين "الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيَّته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبّه والإقبال عليه في محلّ هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهمُّ كلُّه في الله، والخطرات كلُّها بذكره، والتفكُّر في تحصيل مراضيه وما يقرِّب منه، فيصير أنسه بالله بدلًا عن أنسه بالخلق، فيعدّه بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم.
ولمَّا كان هذا المقصود إنَّما يتمُّ مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيَّام الصوم، وهي العشر الأخيرة من رمضان، ولم ينقل عن النَّبيّ، صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه اعتكف مفطرًا قطُّ ، بل قد قالت عائشة رضي الله عنها : لا اعتكاف إلَّا بصوم.
ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلَّا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا مع الصوم، فالذي عليه جمهور السلف أنَّ الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجِّحه شيخ الإسلام ابن تيميَّة.
ثمَّ قال رحمه الله: كان صلَّى الله عليه وسلَّم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتَّى توفاه الله عزَّ وجلَّ، وتركه مرَّة فقضاه في شهر شوَّال، واعتكف مرَّة في العشر الأول، ثمَّ الوسطى، ثمَّ العشر الأخيرة يلتمس ليلة القدر.. ثمَّ تبيَّن له أنَّها في العشر الأواخر فداوم على الاعتكاف فيها حتَّى لحق بربّه عزَّ وجلَّ.
وكان النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم يأمر بخباء فيضرب له في المسجد، يخلو فيه بربّه عزَّ وجلَّ، وكان إذا أراد الاعتكاف صلَّى الفجر ثمَّ دخل معتكفه.. وأمر به مرَّة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهنَّ فضربت، فلمَّا صلَّى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه قوِّض، وترك الاعتكاف في رمضان هذه السنة حتَّى قضاه معتكفًا العشر الأول من شهر شوَّال.
وكان يعتكف في كلّ سنة عشرة أيَّام فلمَّا كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا، وكان جبريل يعارضه القرآن كلّ سنة مرّة فلمَّا كان ذلك العام توفي فيه عارضه مرَّتين. وكان إذا اعتكف دخل قبَّته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلَّا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجّله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض.. وكان أحيانًا يزوره بعض أزواجه وهو معتكف فإذا قامت تذهب قام معها.. ولم يباشر النَّبيُّ امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها.
وكان إذا خرج من المسجد لحاجة يمرُّ على المريض وهو على طريقه فلا يعرِّج عليه، ولا يسأل عنه، واعتكف مرَّة في قبَّة تركيَّة وجعل علي سدَّتها حصيرًا، وكلّ هذا تحصيلًا لمقصود الاعتكاف.
ولعلَّ من الحكمة أن نستلهم الدروس والعبر من هدي الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم في الاعتكاف، فينبغي على المعتكف ألَّا يعكر اعتكافه أو يفسده بأمور الدنيا فيجعل معتكفه مأوى للزوار وتبادل أطراف الحديث، أو يجعل معتكفه مجالًا لأصناف المطعومات، أو يجعله حلبة مصارعة أو مكانًا للَّعب أو الحديث أو نحو ذلك، بل ينبغي أن يجعل معتكفه خلوة لذكر الله وتلاوة القرآن وغير ذلك من العبادات المشروعة.
وأمَّا عن هدي الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم في أخلاقه وسلوكه وتعامله فيقول المؤلِّف: إنَّ من نعم الله علينا أن نحيا في ظلال سيرة هذا الرسول العظيم صلَّى الله عليه وسلَّم القوليّة والعمليّة، ونحيي سلوكه وتصرُّفاته ونتمثَّلها أمام أعيننا نظريًّا ونطبِّقها في واقع حياتنا عمليًّا سواء ما يتعلَّق منها بأخلاقه وسلوكه وتعامله؛ فقد جمع صلَّى الله عليه وسلَّم من الصفات الحسنة أفضلها، ومن الأخلاق الكريمة أزكاها، ومن السمات الفاضلة أعلاها، ولا أعظم من وصف الله سبحانه وتعالى له بها في وصفٍ جامع كريم حيث قال سبحانه وتعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].
ولقد بيَّن الله عزَّ وجلَّ صورة من صور هذا الخلق العظيم، بقوله سبحانه: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ{ [آل عمران: 159].
ولقد حقق النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم هذه الأخلاق الكريمة تحقيقًا عمليًّا في حياته؛ فها هو أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عشر سنين فما قال لي أفٍّ قطُّ، وما قال لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟.
وإذن فقد كان رسول الله أحسن الناس خلقًا، وأعظمهم سكينة وأفضلهم معاملة للناس، بل جعل مهمَّته في هذه الحياة وسبب بعثته ورسالته هي نشر الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "إنَّما بعثت لأتمَّم مكارم الأخلاق".
فلو أراد متأمِّل أن يستنتج أخلاقه، عليه الصلاة والسلام، فلا بدَّ له من دراسة القرآن الكريم، والسنة النَّبويَّة والسيرة العطرة، فإنَّه يتمثَّل هذه الصفات بأسمى صورها، وأجلى معانيها، فإذا بحثت عن التواضع والتحمُّل أو العفاف والحياء أو الإخلاص والصدق أو طيب الكلام وحسن الفعال أو الصبر والمثابرة أو الأمانة والسموّ أو النظافة والطهارة أو الوفاء بالعهد وصدق الوعد، وإفشاء السلام، وحسن الحديث أو الكرم والجود؛ فكلُّ ذلك وغيره قد تمثَّله النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما لم يجتمع لأحد غيره من الخلق.
وقد أخرج الشيخان عن نبيّ الله قال: " إنِّي لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبيّ فأتجوَّز في صلاتي لما أعلم من وجد أمِّه من بكائه".
وكان من رحمته بالحيوان ما ذكره عبد الرحمن بن عبد الله، قال: كنَّا مع رسول الله في سفر فرأينا حمرة "يعني طائر مثل العصفور" معها فرخان لها، فأخذناهما فجاءت الحمرة ترفرف، فلمَّا جاء رسول الله قال : "من فجع هذه بولدها ردُّوا ولدها إليها".
وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم شيئًا قطُّ فقال: لا.
فهذه صور ونماذج حيَّة من كريم أخلاقه وعظيم شمائله صلَّى الله عليه وسلَّم، فحريٌّ بالمسلم أن يتمثَّل هذه الأخلاق ويقتفي أثر هذه الصفات ليتحلَّى بها فيفوز بمنقبة الاقتداء بسمته، وشرف الاهتداء بهديه صلَّى الله عليه وسلَّم .