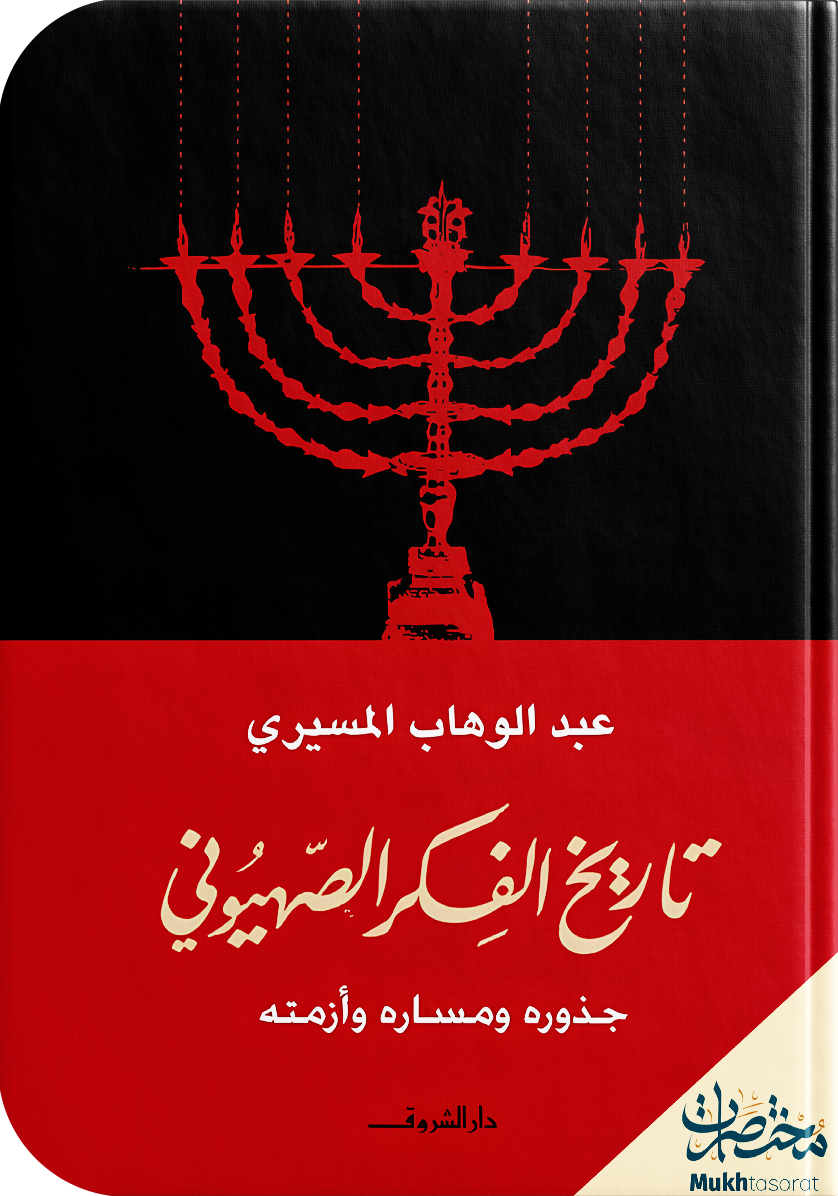تحدَّث د. عبد الوهاب المسيري وقال إنَّ الصهيونيَّة ليست "القوميَّة اليهوديَّة "، وليست "القوميَّة الإسرائيليَّة" كما يدَّعي الصهاينة، فهي أيديولوجيا سياسيَّة غربيَّة ذاتُ توجُّهٍ استعماريّ استيطانيّ إحلاليٍّ وديباجاتٍ يهوديّة، وكلمة "صهيونيَّة " كلمة شائعة يستخدمها الجميع في الشرق والغرب.
وقد وضّح الكاتب أنَّ الدولة الصهيونيَّة أُسِّست تحقيقًا لفكرة القوميَّة اليهوديَّة ، ووضَّح أنَّ زيف مقولة "القوميَّة اليهوديَّة" هو في فشل الدولة اليهوديَّة في تعريف اليهوديّ، أيْ في تعريف ما يسمَّى "الهُويَّة اليهوديَّة"، وحينما يهاجر أعضاء الجماعات اليهوديَّة المختلفة إلى أمريكا اللاتينيَّة فإنَّهم يكتشفون عدم تجانسهم؛ إذ أنَّ اليهوديّ الألمانيّ يكتشف أنّ الصفات الإثنيَّة المشتركة بينه وبين المهاجر الألمانيّ غير اليهوديّ أكثر من السمات المشتركة بينه وبين أعضاء الجماعات اليهوديَّة الآخرين.
وتحدَّث الكاتب عن العلمنة في المجتمعات الغربيَّة، وقد ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونيَّة في أوساط الفلاسفة والمفكرين السياسيِّين والأدباء، تنادي بإعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أنَّهم شعبٌ عضويٌّ منبوذ تربطه علاقةٌ عضويَّةٌ بها استنادًا إلى أسباب تاريخيَّةٍ وسياسيَّةٍ بل وعلميَّة.
وبسبب هذا فإنَّ تاريخ الصهيونيَّة هو بالدرجة الأولى جزء لا يتجزَّأ من تاريخ الحضارة الغربيَّة، ولا يمكن فهمه خارج حركيَّات هذا التاريخ، ونستخدم الصيغة الصهيونيَّة الأساسيَّة الشاملةَ كوحدةٍ تحليليَّةٍ تبسيطيَّةٍ أساسيَّةٍ نقدِّم من خلالها تاريخ الصهيونيَّة، ولنا أن نلاحظ أنَّ التاريخ الذي نقدِّمه من خلال الصيغة اليهوديَّة في الغرب إلى جماعاتٍ وظيفيَّةٍ وبفقدانها هذا الدور في عصر النهضة، وهو الأمر الذي أدّى إلى تصاعد حِمى معاداة اليهود وتزايد وتيرة الدعوة الصهيونيَّة بين غير اليهود ثمَّ بين اليهود؛ هو إطارٌ تاريخيٌّ عامٌّ ينتظم تاريخَ الغرب وتاريخ الصهيونيَّة بين غير اليهود واليهود وتاريخَ معاداة اليهود، ونحن نُصِرُّ دائمًا على ما نسمِّيه "نظرية الصهيونيّتَين"، أي أنَّ هناك صهيونيّتَين؛ واحدة توطينيّة وأخرى استيطانيّة، لكلٍّ رؤيتُها وتاريخُها ومصالحها وجماهيرها ولكنَّهما تحالفتا بعد صدور وعد "بلفور".
ولكنْ رَغم هذا التحالف فإنَّ كلَّ صهيونيَّة لا تزال محتفظةً بتوجُّهِها ومقاصدِها وجماهيرها .
وينقسم تاريخ الصهيونيَّة إلى أربع مراحل أساسيَّة:
وقد تحدَّث الكاتب عن المستوى الأيديولوجيِّ، ويُلاحظ في عصر نهاية الأيديولوجيا وما بعد الحداثة، أنَّ كلَّ النظريَّات تتقلَّص ويختفي المركز. والشيءُ نفسُه يسري على الصهيونيَّة إذ أنَّ إيمان يهود العالم بها قد تقلَّص تمامًا؛ ولذا فإنَّ من يهاجر إلى إسرائيل إنَّما يفعل ذلك لأسبابٍ نفعيَّةٍ ماديَّةٍ مباشرة، وفي داخل إسرائيل تظهر أجيالٌ جديدة تَنظر إلى الصهيونيَّة بكثير من السخرية، وعلى المستوى التنظيميِّ تفقد المنظَّمة كثيرًا من حيوِيَّتِها وتصبح أداة في يدِ الدولة الصهيونيَّة، وتقابل اجتماعاتُها بالازدراء من قِبَل يهود العالم والمستوطنين في فلسطين، ولم تُغيِّر اتِّفاقيَّة أوسلو من الأمر كثيرًا، بل لعلَّها تُسرع بتفاقم أزمة الصهيونيَّة، باعتبار أنَّ الدولة ستصبح أكثر ثباتًا واستقرارًا وستتحدَّد هُوِيَّتُها كدولةٍ لها مصالحُها الاقتصاديَّةُ والإستراتيجيَّةُ المتشبِّعةُ التي ليس لها بالضرورة علاقةٌ كبيرة بأعضاء الجماعات اليهوديَّة في العالم، ويستمرُّ الفلسطينيُّون العرب في المقاومة، ويرفضون الاختفاء، وتندلع الانتفاضةُ وتُطَوِّر إسرائيلُ قوانينَ عنصريَّةً ومفاهيمَ أمنيَّة ومؤسَّساتٍ قمعيَّةً هي في جوهرها عدوانٌ على الفلسطينيِّين، وتصل المسألة إلى الذُروة في تفكير "نتنياهو" و"باراك" و"شارون" الذين يرفضون أيَّ سلامٍ مبنيٍّ على العدل، ويطرحون رؤيةً للسلام المبنيِّ على موازين القوى السائدة في الوقت الحالي، أي أنَّهم يطالبون بالسلام المبنيِّ على الحرب .