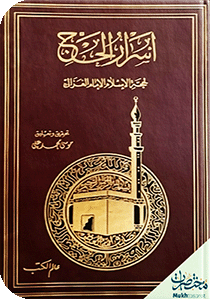بيان دقائق الآداب، وهي عشرة:
الأول: أن تكون النفقة حلالا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم حتى يكون الهم مجردا لله تعالى والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره.
وقد روي في خبر من طريق أهل البيت: "إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف: سلاطينهم للنزهة وأغنياؤهم للتجارة وفقراؤهم للمسألة وقراؤهم للسمعة"، وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصور أن تتصل بالحج.
الثاني: أن لا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والأعراب المترصدين في الطريق؛ فإن تسليم المال إليهم إعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم فهو كالإعانة بالنفس؛ فليتلطف في حيلة الخلاص، فإن لم يقدر فقد قال بعض العلماء - ولابأس بما قال - إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة؛ فإن هذه بدعة أحدثت، وفي الانقياد لها ما يجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصغار للمسلمين ببذل جزية. ولا معنى لقول القائل إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر؛ فإنه لو قعد في البيت أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شيء، بل ربما يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته، فلو كان في زي الفقراء لم يطالب، فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار.
الثالث: التوسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف بل على اقتصاد.
الرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال كما نطق به القرآن.
الخامس: أن يحج ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل.
السادس: أن لا يركب إلا زاملة أما المحمل فليجتنبه إلا إذا كان يخاف على الزاملة ألا يستمسك عليها لعذر، وفيه معنيان؛ أحدهما: التخفيف على البعير فإن المحمل يؤذيه. والثاني: اجتناب زي المترفين المتكبرين.
السابع: أن يكون رث الهيئة أشعث أغبر غير مستكثر من الزينة ولا مائل إلى أسباب التفاخر والتكاثر لئلا يكتب في ديوان المتكبرين والمترفهين.
وفي الحديث: "إنما الحاج الشعث التفث، ويقول الله تعالى: "انظروا إلى زوار بيتي قد جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق"، وقال تعالى: "..ثم ليقضوا تفثهم.." والتفث الشعث والاغبرار، وقضاؤه بالحلق وقص الشارب والأظفار.
الثامن: أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق، والمحمل خارج عن حد طاقتها، والنوم عليها يؤذيها ويثقل عليها.
التاسع: أن يتقرب بإراقة دم وإن لم يكن واجبا.
وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: "ما عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراقه دما، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا"، وفي الخبر: "لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا"، وقال ﷺ: "استنجدوا هداياكم فإنها مطاياكم يوم القيامة".
العاشر: أن يكون طيب النفس بما أنفقه من نفقة وهدي وبما أصابه من خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك؛ فإن ذلك من دلائل قبول حجه.
ويقال: إن من علامة قبول الحج أيضا ترك ما كان عليه من المعاصي وأن يستبدل بإخوانه البطالين إخوانا صالحين، وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة.
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة
وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره
اعلم أن أول الحج الفهم - أعني فهم موقع الحج في الدين - ثم الشوق إليه ثم العزم عليه ثم قطع العلائق المانعة منه ثم شراء ثوب الإحرام ثم شراء الزاد ثم اكتراء الراحلة ثم الخروج ثم المسير في البادية ثم الإحرام من الميقات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استتمام الأفعال كما سبق.
وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن. فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشف لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه.
أما الفهم، فاعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار على الضرورات فيها والتجرد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات. وقد أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لها، فشرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى، ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره، وجعل عرفات كالميزاب على فناء حوضه، وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق، شعثا غبرا متواضعين لرب البيت، ومستكينين له؛ خضوعا لجلاله واستكانة لعزته.
ولذلك وظف عليهم فيه أعمالا لا تأنس بها النفوس، ولا تهتدي إلى معانيها العقول؛ كرمي الجمار بالأحجار، والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية.ولذلك قال ﷺ في الحج على الخصوص: "لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا"، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها.
وأما الشوق، فإنما ينبعث بعد الفهم والتحقق بأن البيت بيت الله عز وجل فقاصده قاصد إلى الله عز وجل، وزائر له، وأن من قصد البيت في الدنيا جدير بأن لا يضيع زيارته، وهو يرزق مقصود الزيارة في ميعاده المضروب له؛ وهو النظر إلى وجه الله الكريم في دار القرار.
وأما العزم، فليعلم أنه بعزمه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات، ومتوجه إلى زيارة بيت الله عز وجل. وليعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت، وليعلم أنه عزم على أمر رفيع شأنه خطير أمره، وأن من طلب عظيما خاطر بعظيم. وليجعل عزمه خالصا لوجه الله سبحانه بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة، وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص، وأن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الله وحرمه والمقصود غيره. فليصحح مع نفسه العزم، وتصحيحه بإخلاصه، وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء وسمعة، فليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.
وأما قطع العلائق، فمعناه رد المظالم والتوبة الخالصة لله تعالى والإقلاع عن جملة المعاصي.
فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فنفذ أوامره ورد المظالم وتب إليه أولا من جميع المعاصي واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك لتكون متوجها إليه بوجه قلبك كما أنك متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك.
وليكتب الزائر وصيته لأولاده وأهله؛ فإن المسافر لعلى خطر إلا من وقى الله سبحانه.
وأما الزاد، فليطلبه من موضع حلال، وليتذكر أن سفر الآخرة أطول من هذا السفر، وأن زاده التقوى، وأن ما عداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويخونه فلا يبقى معه.
وأما الراحلة، إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه على تسخير الله عز وجل الدواب؛ له لتحمل عنه الأذى، وتخفف عنه المشقة. وليتذكر عنده المركب الذي يركبه إلى دار الآخرة وهي الجنازة التي يحمل عليها؛ فإن أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة.
وأما شراء ثوبي الإحرام، فليتذكر عنده الكفن ولفه فيه فإنه سيرتدي ويتزر بثوبي الإحرام عند الاقتراب من بيت الله عز وجل وربما لا يتم سفره إليه، وأنه سيلقى الله عز وجل ملفوفا في ثياب الكفن لا محالة.
وأما الخروج من البلد، فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى الله عز وجل في سفر لا يضاهي أسفار الدنيا، فليستحضر في قلبه أنه ماذا يريد، وأين يتوجه، وزيارة من يقصد؟، وأنه متوجه إلى ملك الملوك في زمرة الزائرين له الذين نودوا فأجابوا، وشوقوا فاشتاقوا، واستنهضوا فنهضوا، وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله عز وجل.
وأما دخول البادية إلى الميقات ومشاهد تلك العقبات، فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات، وليتذكر من هول قطاع الطريق هول سؤال منكر ونكير، ومن سباع البوادي عقارب القبر وديدانه وما فيه من الأفاعي والحيات، ومن انفراده من أهله وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته، وليكن من هذه المخاوف في أعماله وأقواله متزودا لمخاوف القبر.
وأما الإحرام والتلبية من الميقات، فليعلم أن معناه إجابة نداء الله عز وجل، فارج أن تكون مقبولا واخش أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك، فكن بين الرجاء والخوف مترددا، وعن حولك وقوتك متبرئا، وعلى فضل الله عز وجل وكرمه متكلا؛ فإن وقت التلبية هو بداية الأمر، وإن التلبية هي محل الخطر. قال سفيان بن عيينة: حج علي بن الحسين رضي الله عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي فقيل له: لم لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه.وليتذكر الملبي عند رفع الصوت بالتلبية في الميقات إجابته لنداء الله عز وجل إذ قال: "﴿..وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا..﴾ ونداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لنداء الله سبحانه؛ ومنقسمين إلى مقربين وممقوتين، ومقبولين ومردودين، ومترددين في أول الأمر بين الخوف والرجاء تردد الحاج في الميقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم إتمام الحج وقبوله أم لا؟.
وأما دخول مكة، فليتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى آمنا وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله عز وجل، وليخش أن لا يكون أهلا للقرب فيكون بدخوله الحرم خائبا ومستحقا للمقت. وليكن رجاؤه في جميع الأوقات غالبا؛ فالكرم عميم والرب رحيم وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعي وذمام المستجير اللائذ غير مضيع.
وأما وقوع البصر على البيت، فينبغي أن يستحضر عنده عظمة البيت في القلب، وأن يقدر كأنه مشاهد لرب البيت لشدة تعظيمه إياه. وارج أن يرزقك الله تعالى النظر إلى وجهه الكريم كما رزقك الله النظر إلى بيته العظيم، واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه إياك بزمرة الوافدين عليه. واذكر عند ذلك انصباب الناس في القيامة إلى جهة الجنة آملين دخولها كافة، ثم انقسامهم إلى مأذونين في الدخول ومصروفين عنه انقسام الحاج إلى مقبولين ومردودين. ولا تغفل عن تذكر أمور الآخرة في شيء مما تراه؛ فإن كل أحوال الحاج دليل على أحوال الآخرة.
وأما الطواف بالبيت، فاعلم أنه صلاة فأحضر في قلبك فيه من التعظيم والخوف والرجاء والمحبة، واعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكة المقربين الحافين من حول العرش الطائفين حوله. ولا تظنن أن المقصود طواف جسمك بالبيت؛ بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لا تبتدئ الذكر إلا منه، ولا تختتم إلا به؛ كما تبدأ الطواف من البيت وتختم بالبيت. واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القلب بحضرة الربوبية، وأن البيت مثال ظاهر في عالم الملك لتلك الحضرة التي لا تشاهد بالبصر وهي عالم الملكوت.
وأما الاستلام، فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وجل على طاعته، فصمم عزيمتك على الوفاء ببيعتك.
وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم، فلتكن نيتك في الالتزام طلب القرب؛ حبا وشوقا إلى البيت وإلى رب البيت، وتبركا بالمماسة ورجاء للتحصن عن النار في كل جزء من بدنك لا في البيت. ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان؛ كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه، المتضرع إليه في عفوه عنه، المظهر له أنه لا ملجأ له منه إلا إليه، ولا مفزع له إلا كرمه وعفوه، وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن في المستقبل.
وأما السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت، فإنه يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى؛ إظهارا للخلوص في الخدمة، ورجاء للملاحظة بعين الرحمة؛ كالذي دخل على الملك وخرج وهو لا يدري ما الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أو رد، فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى يرجو أن يرحم في الثانية إن لم يرحم في الأولى.
وأما الوقوف بعرفة، فاذكر - بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات - عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة واقتفاء كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. وإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل.
وأما رمي الجمار، فاقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه. ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية، فأمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله.
واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه.
وأما ذبح الهدي، فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال، فأكمل الهدي وارج أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار؛ فهكذا ورد الوعد.
وأما زيارة المدينة، فإذا وقع بصرك على حيطانها فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله - عز وجل - لنبيه ﷺ، وجعل إليها هجرته، وأنها دار النبي التي شرع فيها فرائض ربه - عز وجل - وسننه، وجاهد عدوه وأظهر بها دينه، إلى أن توفاه الله عز وجل، ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القائمين بالحق بعده رضي الله عنهما.
وأما زيارة رسول الله ﷺ، فينبغي أن تقف بين يديه كما وصفناه، وأن تزوره ميتا كما تزوره حيا، وألا تقرب من قبره، إلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا؛ فإن اللمس والتقبيل عند اللقاء والمشاهدة عادة النصارى واليهود، واعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك، وأنه يبلغه سلامك وصلاتك.
فإذا فرغ من المناسك والأعمال كلها فينبغي أن يلزم قلبه الحزن والهم والخوف؛ لأنه ليس يدري أقبل منه حجه وأثبت في زمرة المحبوبين، أم رد حجه وألحق بالمطرودين.
وليتعرف على ذلك من قلبه وأعماله، فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا (أي ابتعادا) عن دار الغرور، وانصرافا إلى دار الأنس بالله تعالى، ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع؛ فليثق بالقبول؛ فإن الله تعالى لا يقبل إلا من أحبه، ومن أحبه فإنه يتولاه ويظهر عليه آثار محبته، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فيوشك أن يكون حظه من سفره العناء والتعب.
نعوذ بالله - سبحانه وتعالى - من ذلك.